المدربون المعتمدون.. بائعو الوهم الجدد
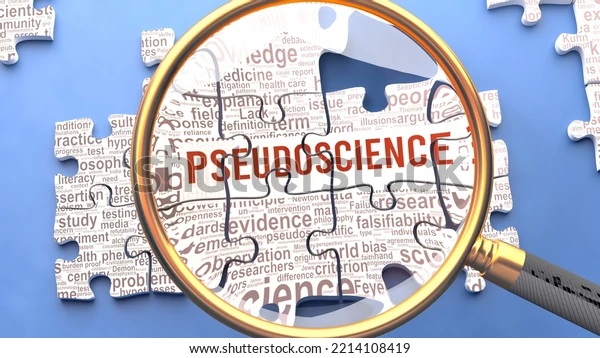
بعدما تبين للناس زيف معظم ما يتكلم به رواد التنمية البشرية و”الطاقة”، أفل نجم هذه الفنون، وتراجعت المكاسب التي يجنيها من ركبوا هذه الموجة، الأمر الذي جعل العديد منهم يتبع طرقاً ومسارات تعوض ما خسروه، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو فاسد، المهم ألا يشار إلى تاريخهم بأنهم مضلّلِون، أو بأسوء الأحوال كذّابون.
ومع بدء فصل الصيف واتجاه الأهالي لتسجيل أبناءهم بالنوادي الصيفية، يرغب الأهل في استثمار هذه الفترة بتعليم أبنائهم ما يفيد، ساعين إلى من يدمج التعلم بالأساليب التي تجذب الأطفال من ألعاب وغيرها.
وفي نفس الوقت، تعتبر هذه الفترة وقتاً ذهبياً لمدّعي العلم لينشروا أفكارهم وطرقهم بين الناس، مستهدفين عامة الناس والفئات العمرية الصغيرة ذات الخبرة القليلة، ونظرًا للمكانة العالية للعلم في المجتمع، فإن محاولات المبالغة في الحالة العلمية لمختلف الادعاءات والتعليمات والمنتجات شائعة بما يكفي لجعل قضية ترسيم الحدود ملحة في العديد من المجالات، لذلك فإن مسألة الترسيم مهمة في التطبيقات العملية الحياتية كالتعليم.
ما دفعنا للتنبيه والإشارة إلى خطر هؤلاء على الأطفال وعلى المجتمع بشكل عام، وسنورد مثالين لرواد هذا الحقل.
وهنا نريد التأكيد بأننا لسنا بصدد التشهير بأي أحد بقدر رغبتنا في زيادة وعي الناس، برفع الغطاء عن هؤلاء، وكشف أحوالهم التي تميزهم عن المختصين الحقيقيين، ليتجنب الناس الذهاب إليهم وتسجيل أولادهم.
مدرب “فيزياء الكم” يعالج “بالطاقة” أيضاً!
السيدة (س.ح) من حلب، تدعي أنها مدربة حساب ذهني وألعاب ذكاء، تقدم دورات وورشات تعليمية لمختلف الأعمار وخصوصاً الأطفال حسب ما وجدنا من مقاطع لها على حسابها في فيسبوك الذي يتابعه أكثر من 2500 شخص.
بتتبع منشورات حسابها نجد منشوراً لنادٍ صيفي ستقدم فيه “المدربة” جلسات تدريبية حول مواضيع عدة أبرزها “فيزياء الكم”، “النانو تكنولوجي”، “البيولوجيا الجزيئية”، ولعل هذه المواضيع الرنانة تعطي انطباعاً بأن الطلاب سيكونوا على الأقل في المرحلة الثانوية على أقل تقدير، لما فيها من تعقيد يصعب حتى على المتخصص فهمها بالشكل الصحيح.
إلا أنه لم يكن كذلك، فالنادي الصيفي سيكون للفئات العمرية بين 9 – 15 سنة بحسب الإعلان، أي لطلاب لم يبلغوا المرحلة الثانوية حتى!.
مسلسل المفاجآت لم تنتهي بعد، من المنطقي والمفترض أن يكون “مدرب” هذه العلوم الحديثة حاصل على درجة علمية أكاديمية عالية تؤهله للحديث عن هذه العلوم، إلا أن هذا لا ينطبق على السيدة المذكورة، فهي ليست خريجة أي قسم علمي مرتبط بهذه العلوم، وإنما خريجة اقتصاد من جامعة حلب، أي أنها لم تحصل على أي شهادة علمية معتبرة تؤهلها لتقديم ذلك، بحسب ما علمنا منها في حديث غير مباشر معها.
وعند الاطلاع على معلوماتها في حسابها في فيسبوك، نجد أنها تعمل في شركة لمنتجات التجميل، وتعالج -بالإضافة لما سبق- “بالطاقة الحيوية” و”بتقنية الوصول إلى مسارات الوعي”، ولمن لا يعلم، فهذه الأمور تعرف في الوسط العلمي بـ”العلوم الزائفة”.
العلوم الزائفة أو (pseudoscience) هي التصريحات، أو الاعتقادات أو الممارسات التي يزعم بأنها علمية وحقيقية معاً، دون أن تكون متوافقة مع المنهجية العلمية، فهي في الظاهر تبدو علماً، إلا أن باطنها بعيد كل البعد عن العلم الحقيقي، وعلم الطاقة والبارابسيكولوجي يندرجان ضمن العلوم الزائفة (pseudoscience) كما تصنّفه الغالبية العظمى من العلماء والمختصين في الفيزياء وعلم النفس.
انتهيت من حضور تدريب؟.. هيا بنا لنصبح مدربين أيضاً
عند سؤالها عن المؤهل الذي سمح لها بـ”تدريب” هذه البرامج، أجابت بأنها خضعت لتدريب مكثف ضمن أحد المراكز التدريبية -وليس من معهد أو جامعة- وأخذت شهادة تخولها بالقيام بذلك.
والسؤال المهم هنا: ومنذ متى كان يُسمح لـ”متدرب” بتدريس علوم تخصصية غاية في التعقيد كفيزياء الكم؟!
المتعارف والصحيح بأنه من غير المقبول أن يتقدم أحد ويدرس مثل هذه العلوم التخصصية إلا إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم وهو الدرجة الأكاديمية من إحدى الجامعات في هذا المجال أو في مجال قريب على أقل تقدير، وذلك لوجود أساسيات يمتلكها الدارس سنوضحها لاحقاً.
“ما المشكلة في ذلك؟ فهذا “المدرب” يبذل جهداً وينشر علماً؟”
المشكلة الجوهرية ليست في نشره للعلم، فالمعلومات المقدمة موجودة مسبقاً في الكتب والانترنت، المشكلة هي أن انتشار هذه الأشكال في مجتمعاتنا يثبت أن هناك مشكلة في الوعي العام، وقدرة هؤلاء على التأثير على عامة الناس من خلال استخدام كلمات معقدة وغير مألوفة لدى الناس لإيهامهم بأن هذا التدريب سيخرج كل طاقات أبنائهم وقدراتهم الكامنة ويجعلهم مؤهلين ليصبحوا في المستقبل علماء وفطاحل في المجالات العلمية الحديثة، وهنا لب القضية التي نطرحها اليوم.
يحاول مروجو بعض العلوم الزائفة بشتى الطرق إدخال تعاليمهم في المناهج المدرسية، ما يؤكد على حاجة المعلمين ومدراء المدارس إلى معايير واضحة للإدماج تحمي الطلاب من التعاليم غير الموثوقة والمفسدة.
هذه البديهيات يُفترض أن كل شخص يمتلكها ليستخدمها في التفكير وتمحيص الأمور وتمييز الحق من الباطل في عموم المسائل، هي في الأساس تزرع في عقل الطفل في المدارس الابتدائية، فيُعلّم كيفية التفكير المنطقي النقدي، وهذا بالضبط ما يلزم التركيز عليه في هذه المرحلة العمرية، وغيرها من الأساسيات التي تحفظ المجتمع ككل من هؤلاء التافهين ومن الترهات التي يتكلموا بها، وإلا سيُفتح الباب على مصراعيه لمن هبّ ودبّ في أن يحكي ما لا يعلم، ويفتي فيما لا يفهم.
وقد يتساءل أحدهم: “وما المانع من أن يدرس -أو كما يقولون يدرب- هذا الشخص هذه المواد ما دام يمكنه القراءة في هذه التخصصات كأي شخص متخصص؟”
الموضوع لا يتعلق بالقراءة بحد ذاتها، بل يتعلق بالمنهجيات والطرق التحليلية والأسس العلمية والفكرية التي يكتسبها المتخصص خلال دراسته، وخلال تعلمه وتدربه على يد المتخصصين من الجيل السابق، وهي جوهر ما يميزه عن غير المتخصصين.
فالتصدر في هذه المجالات يحتاج للمتميز فعلاً سنوات عديدة ليصل إلى مرتبة محترمة في الوسط العلمي تؤهله للحديث في هذه المجالات، وهذا يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين ممن سيسلك هذه الطرق السليمة، ففي البداية يدرس ويتعلم على أيدي مختصين أصحاب درجات علمية عالية، ومن ثم يُفحص ويُختبر علمه وعمله، ومن ثم يحصل على الشهادة التي تشهد له بذلك كله.
“قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ”
الاختصاص يُكسب صاحبه سلطة في مجاله، وهم يسعون لكسب هذه السلطة بأقل جهد وأقصر وقت ممكن، مستغلينها في نشر أفكارهم دونما رقيب أو حسيب، وهذا الأمر لا يرتبط بسوريا فحسب، بل موجود في كل دول العالم، وبدرجات متفاوتة، وخصوصاً في البلدان التي تعاني من الاضطرابات والأزمات، أي عندما لا يكون هذا الأمر أولوية بنظر المعنيين.
وهذه واحدة من المسؤوليات الكبرى التي تقع على عاتق الجهات المعنية من وزارات ومنظمات وجمعيات علمية محلية ومراكز تعليمية وتدريبية، فلو كان هناك رقابية علمية حقيقية في كل تلك الجهات لما سمحت لهؤلاء بالظهور، بل وعاقبتهم على ما يفعلونه، فما بالك لو كانت هذه الجهات هي من تدعم وتروّج لهم؟!.
وأيضاً لا ننسى دور الجامعات في تخريج الطلاب يمتلكون بالفعل أدوات العلم والبحث العلمي في كافة التخصصات، وليسوا مجرد طلاب تمكنوا من تخطي الامتحانات، والحديث هنا يطول.
كل ما سبق وغيره يدفع هؤلاء ليسلكوا طرقاً ملتوية للوصول لتلك المرتبة، تارةً بالخضوع لتدريب مكثف في أحد المراكز التدريبية، وليس في جامعات أو معاهد أكاديمية محترمة فذلك يتطلب جهداً كما أسلفنا، وتارةً في المشاركة في أحد المؤتمرات، وتارةً في المشاركة في عدة معارض علمية، فإذا سجّلوا ذلك في سيرهم، وحفظوا عدة كلمات وفهموا عدة مسائل تخصصية، صدّروا أنفسهم كأخصائيين متمكنين في المجال المُعتدى عليه، وهذا ينفع ويعطي نتائج باهرة، ويفتح أبواباً لمكاسب مالية ومادية كبيرة لم يحلموا بها من قبل، وهذا ما يدفعهم للتجرؤ على فعلهم المقيت، فلا يحترموا هذه التخصصات ولا حتى أصول العلم الحقيقي.
عواطف الناس.. النقطة الأكثر ضعفاً
اللعب على وتر العاطفة هو أساس عملهم، فغالبية الناس في البلدان الغارقة في الأزمات يسعون إلى جعل أبناءهم متميزين علمياً ليتمكنوا من السفر للخارج ويؤمّنوا حياة جيدة ومرفهة تمكنهم من دعم أهليهم مادياً في الداخل، وقلة الوعي لديهم تدفعهم لتصديق ما يقوله هؤلاء، بأن هذه الدورات والورشات ستمكن أبناءهم من الحصول على القدرات العلمية والذهنية اللازمة للتميز الأكاديمي.
وهذا بالفعل ما يروج له السيد (ع.د) عبر منشوراته بانتظام، حيث تُظهر إعلانات دوراته ذلك بكل وضوح، بأن حضور هذه الدورات سيجعل ابنك عبقرياً ومتفوقاً، لا على زملائه فحسب، بل على الآلة الحاسبة أيضاً!
وبأن البرنامج الفلاني هو برنامج عالمي، أي أن طفلك سيتعلم وفق المعايير العالمية، وهذا لا يتجاوز كونه وهماً في وهم.
وهذا يغوص بنا إلى داخل نفوس الأهالي للوصول إلى الفكرة الأولى المزروعة بقوة، بأن من يدرس في الجامعات الحكومية أو المحلية لن يكون ناجحاً مقارنةً بمن يدرس في الخارج، ولمواقع التواصل الاجتماعي الأثر البالغ في تمكين هذه الفكرة لديهم، ولو أن فيها بعض الصحة، إلا أنها تفتقد للموضوعية، فليس كل من درس في الخارج ناجح، ولا كل من درس في الداخل فاشل، الأمر كله يتعلق بالجهد المبذول من الطالب -ومن الطالب حصراً- في تحصيله للعلم، بغض النظر عن مكان دراسته، وأعرف العديد من الطلاب تنطبق عليهم الحالات السابقة.
وعلى الجانب الآخر، نجد العديد من العلماء والخبراء والمختصين الحقيقيين والذين تشهد لهم الجامعات والمراكز البحثية والمجلات المحكمة على إنجازاتهم الضخمة، وقدراتهم الفذة، وأبحاثهم المهمة التي أفادت البشرية جمعاء، فتجد ذكرهم نادراً على وسائل الإعلام المحلية، أو لا تجده أصلاً، بل ستجد الاهتمام ينصب على الفنانين والرياضيين، والله المستعان.
إن المشاكل التعليمية والتربوية أهم المشاكل الكبرى التي تعاني منها مجتمعاتنا منذ سنين طويلة، وتزداد سوءً يوماً بعد يوم، وما هي إلا نتاج تَوْسيد أمورنا إلى غير أهلها، وتصديق من يدغدغ عواطفنا ولو سار بنا إلى الضلال، ونبذ من يكلّم عقولنا ويصحح تصرفاتنا، فإذا عزمنا إلى تغيير حالنا لحال أفضل، لا بد لنا من إعادة النظر إلى أنفسنا أولاً، فنحسنها ونوَّعْيها، لنتمكن من تمييز الجهود الرامية إلى التحسين من تلك الهدامة، ومن ثم ندعم الأولى وننبذ الثانية.


